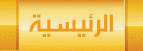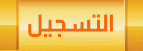لا يزال ملف عالم الشيطان بغرائبه وقصصه الأسطورية مفتوحًا منذ اللحظات الأولى لخلق الإنسان. ورغم ظهور الدين الحق وتقدم العلم وتطور الفكر الفلسفي، فإن الإنسان لا يزال متخبطًا على مدى التاريخ، وإلى اللحظة الحاضرة، في فهم عالم الشيطان المثير، وفي كيفية التعامل معه! وبين مؤيد ومعارض، يستمر الخلاف والجدال، وتبقى الحيرة مستمرة، ويزداد التردد، ولا يتوقف الضلال، ويظل البحث مفتوحًا في قضية ظلت تؤرق كثيرًا من الناس كما تؤرق كل من يبحث عن الحقيقة، رغم كل ما في الإسلام من حقائق نهائية تنطوي على قوة منطق، وأدلة واقعية، تتفق مع تجارب العقلاء في كل زمان ومكان.
ومثلما اختلف الناس حول الشيطان اختلفوا أيضًا حول مشكلة الشر، واستعصى على الجميع فهم المقاصد الإلهية إلا من آمن برسالة السماء. وتنوعت مواقف الفلاسفة من مشكلة الشر في العالم تبعًا لمواقفهم العامة من الدين وطبيعة رؤيتهم الأنطولوجية للعالم. كما تنوعت مواقف الأديان من الشيطان والشر تبعًا لمواقفها العامة من الألوهية وطبيعة رؤيتها للعالم والحياة؛ فهناك من الأديان الوضعية من تفسر وجود الشر في العالم عن طريق الاعتقاد في وجود إله للشر، أو أصل منفصل له في الوجود (أصل قديم لم يخلقه الله، مثل المادة أو الظلام)أو كائن كوني أسطوري مثل الأفعى أو التنين، يدخل في صراع مع إله الخير، مثل: الفيدية، والهندوسية، والمجوسية، والزرادشتية بعد تحريفها، والمانوية.
وهناك من الأديان من يفسر وجود الشر في العالم عن طريق الاعتقاد في وجود شيطان أو شياطين، مثل:اليهودية والمسيحية والإسلام. مع اختلاف بينهم في طبيعة دور الشيطان، وكيفية التغلب عليه، فضلًا عن وجود عناصر أخرى غير الشيطان لتفسير الشر في الإسلام؛ ذلك الدين الذي استطاع أن يتخلص من أساطير القدماء ومن أوهام البشر ومن مغالطات بعض الفلاسفة المتأثرين بالديانات الوضعية أو المحرفة. ورغم أن الشيطان مسؤول عن جزء من الشر في العالم، فإن الإنسان -عندما يضل الطريق- يتحمل جزءًا آخر.
وفي إطار رؤية ديالكتيكية للشر بين الدين والفلسفة، سوف نحاول تحديد طبيعة الرؤية الدينية للشر في العالم متبعين المنهج النقدي المقارن، كاشفين النقاب عن بنية التصور الديني للشيطان ودوره في إحداث الشر في العالم. وفي هذا السياق سوف نستحضر بعض التصورات الفلسفية المتأثرة بالدين أو المضادة له.
الشيطان إلهًا
إذا بدأنا بأهم ديانات المصريين القدماء نجد أن «ست» إله الشر والانتقام والدمار، أفضل من يمثل الشيطان في الديانة المصرية القديمة، ومع ذلك فقد عبده قدماء المصريين من قبيل الخوف لا المحبة. وكان «ست» هو المعبود القومى للصعيد، وعاصمته أمبوس، وكان حيوانه المقدس كلبًا بريًا، وكان رمزه القوة والبأس والعواصف والرعود.
ويقف ست على نقيض أخيه أوزوريس إله الخير والمحبة، وتروى تواريخ الأساطير المصرية أنه تآمر على قتل أوزوريس ليستولي على عرشه، ولكن إيزيس زوجة أوزوريس كانت ساحرة كبرى، نجحت في أن تلقح نفسها من أوزوريس الميت، ثم أنجبت حورس الذي حارب عمه «ست» وانتصر عليه، واسترد العرش السليب. واللافت للنظر بعيدًا عن الموضوع أن المصريين الآن يطلقون في اللغة العامية كلمة «ست» على أي امرأة!
التغيير الشيطاني المخادع وخلخلة نظام الكون
اتخذ الشر شكلًا آخر في الديانة الفيدية الهندية أقدم الديانات الوضعية في العالم، وهي تعبر عن قوى الشر في العالم بمصطلح «مايا Maya»، وهو مشتق من الجذر may بمعنى غيَّر وفي «الريج فيدا» تعنى مايا: التغيير المدمر أو المنكر المنافي للغير، والتغيير الشيطاني والمخادع الذي يؤدي إلى خلخلة نظام الكون، وأيضًا فساد الفساد.
لكن نجد في الفيدية بجوار المايات السيئة مايات خيرة. أما المايات الخيرة فهي على نوعين:
- مايات المعركة: التي يستخدمها اندرا عندما يحارب الكائنات الشيطانية.
- المايات الخالقة: وهي متميزة عن الآلهة العليا، وفي الدرجة الأولى عن فارونا.
ويمكن اعتبار هذه المايا الكونية كمعادلة لريتا. والريتا هي النظام الكوني الشامل في الديانة الفيدية، وتمثل الطبيعة الحق التي تنظم الأشياء، فهي القانون الأبدي الذي ينظم العالم. وهكذا نرى أن المايا تتعلق- كما يشير مرسيا إياد(1) بمفهوم مختلط، بل متناقض، فالمايا ليس مجرد فساد شيطاني للنظام الكوني، وإنما عملية إبداعية إلهية أيضًا. وفيما بعد فإن الكون ذاته سيصبح، بالنسبة للفيدانتا، تحولًا وهميًا ونظامًا من التغيرات مجردًا عن الحقيقة.
وفي الديانة الهندوسية أصبحت المايا تدل على «الوهم»، فالعالم المادي وهم؛ لأن الهندوسية تنظر إلى العالم المحسوس على أنه الشر بعينه الذي يجب تحرر الروح منه. ومن هنا فالمادة في الهندوسية شر، فالمادة هي «مايا»،أي وهم وخداع وباطل.
وإذا عدنا للمايا الشريرة في الفيدية نجد أنها تتعلق بالحيل والسحر، وبخاصة أنواع السحر المتعلق بالتحول لنموذج شيطاني، مثل تلك التي للتنين الجبار فريترا Vritra أو الأفعى الكونية التي هي «ماين Mayin» أي الساحرة.
ومايا التي من هذا النوع تفسد النظام الكوني، فمثلًا تعيق مسير الشمس وتحبس المياه. وفريترا هي الخصم اللدود للنظام الكوني، ودخلت هي وأعوانها من قوى الشر في صراع مع الإله إندرا عند بدء الخليقة.وقد كاد الشر أن يهزم الخير، حيث خاف إندرا في البداية عندما رأى فريترا، وأسرع بالهرب، لكنه عاد وتغلب عليها بقتلها.وأطلق المياه الحبيسة.فقد كان من الضروري مواجهة وقتل هذا الكائن الشرير؛حتى يمكن للوجود والكائنات أن تتولد وتنشأ بواسطة إندرا.وقام إندرا بعد ذلك بقسمة الوجود إلى عالمين:عالم علوي،وعالم سفلي،وأجبر القوى الشريرة على الانعزال في العالم السفلي،هذا العالم الذي لا يوجد فيه نظام ولا قانون ولا نور؛ فهو عالم الاضطراب والفوضى والظلام.
ونجد هذه الرؤية للشر في عديد من أساطير الديانات القديمة،إذ يوجد:«خط مميز وشائع في كل هذه الأساطير، هو الخوف أو خيبة أولى للبطل...»(2). لكن يعقب ذلك انتصار الإله أو البطل.
وفي فارس اتخذ الشر شكلًا إلهيًا أيضًا، ففي ديانة زرادشت(660- 583 ق. م) المحرفة (الأصلية توحيدية وليست ثنائية كما تدل ترانيم زرادشت)، إيمان بنوع من ثنائية الإلهي: الأول باسم أهورامزدا، وهو الإله المضيء والظاهر في ذاته، ونقيضه هو أهريمان، أي الظلام، وهو نجس في ذاته. فمملكة النور لا تستقل وحدها بالعالم، وإنما تقف على النقيض منها مملكة الظلام، وعلى رأسها أهريمان. وينتمي إليها الشر الروحي والطبيعي، وكل ما هو هدام وسلبى. غير أنه غير مسموح لأهريمان إله الشر أن يوسع نفوذه ويبسط سلطانه، حيث إن العالم في مجموعه يسعى إلى تدمير مملكة الظلام وإزالتها نهائيًا، وتأمين حضور أهورامزدا وسيطرته على كل مناحي الحياة.
ووفق هذا التصور لطبيعة الإلهي، تأتى العبادة في الزرادشتية، حيث ينبغى على الإنسان أن يكرس حياته كلها من أجل مملكة النور، فيعمل على تطهير جسمه وروحه، وإشاعة الخير حوله، وأن يتعبد بالقول والفكر لأهورامزدا وكل ما هو منبثق عنه، ومحاربة أهريمان وكل نشاط منبثق عنه. أي أن المجوسي لا يوجه صلواته فقط إلى أهورامزدا، وإنما كذلك إلى جميع ما انبثق عنه تبعًا لدرجته ومقامه من الطهارة والصلاح. فبعد الصلاة إلى أهورامزدا يصلي المجوسي إلى «الأمسشسباندات» وهي الانبثاقات الأولى لأهورامزدا والأكثر سطوعًا وتجليًا، والتي تحيط بعرشه، وتساعده في حكم العالم.
وتستهدف الصلاة التي توجه إلى تلك الأرواح السماوية، خواصها ومهامها بالتحديد، فإذا كانت من الكواكب، فإن الصلاة توجه إليها في زمن ظهورها، وترتفع الابتهالات إلى الشمس نهارًا، وتختلف طبيعة الابتهالات تبعًا لحالة الشمس، من شروق إلى تعامد إلى غروب. ويصلي المجوسي في فترة الضحى لأهورامزدا في المقام الأول حتى يزيد من سطوعه وتجليه، وعندما يأتي المساء يصلى توسلا لأهورامزدا من أجل أن تتم الشمس مسارها. وعندما جاء الإسلام نهى عن الصلاة في تلك الأوقات درءًا للتشبه بالمجوس وحرًصا على التفرد.
وكانت الديانة الميثرائية نوعًا من الديانة الزروانية الفارسية التي كان يعبد فيها كل من ميثرا إله الشمس، وانكرامايندو إله الشر. وكان أتباعها يمارسون شعائر وتعازيم خاصة لتجنيد الشياطين في خدمتهم واستخدامهم ضد أعدائهم أملًا في القضاء عليهم. لكن كان بها فرع يقوم على عبادة إله الشر أو الشيطان فقط وممارسة السحر والجحود والإباحيات. وكانت الميثرائية كديانة للجيش الفارسي تنتشر في الأقطار التي تصلها الجيوش الزروانية. إلا أنها واجهت الضربة القاضية من الديانة المسيحية في القرن الرابع بعد الميلاد .
والشيطان لا وجود له في أساطير اليونان، لكن توجد أرواح شريرة تسمى (Alastores ) وهي تحاول دائمًا أن تزين الضلال للناس ليسلكوا طريق الشر.
أما الغنوصية في القرن الأول للميلاد المعرفة فقد أدخلت كثيرًا من السحر والشعوذة في تعاليمها، وقالت بإمكانية السيطرة على القوى الخفية كالشياطين وغيرهم. وتأثرت في مراحلها المتأخرة بالديانة الثنوية، حيث اعتبرت الشيطان مساويًا لله في القوة والسلطان! وهذا ما تأثرت به المسيحية كما سنرى فيما بعد.
عبادة الشيطان في التاريخ الإسلامي
تنسب عبادة الشيطان في التاريخ الإسلامي إلى اليزيدية التي نشأت بعد انهيار الدولة الأموية، ويقطن أكثر أتباعها الشمال الشرقي من الموصل، وبغداد، ودمشق، وحلب، ومنهم طوائف في إيران وأوران الروسية. وتقوى الشكوك حول هذه الطائفة عند التدقيق العلمي، لأن أغلب الدراسات الشائعة تقول بعبادتهم للشيطان، بينما ثمة دراسات حديثة لا سيما من أبناء هذه الطائفة تنفي هذا. والرؤية التقليدية هي أن اليزيدية تدين بعبادة الشيطان بسبب تأثرها بالعقيدة الزرادشتية، فهم بقية عبدة أهريمان، وقيل لأنهم يعتقدون أن الشيطان تاب والله قبل توبته، فرجع يتعبد مع الملائكة. والذي أسسها حسب هذه الرؤية هو عدي بن مسافر المتوفى حوالي سنة 1154 م الذي قال بتحريم لعن الشيطان. وهناك من يرى أن اليزيدية أخذت هذه التسمية من تأليههم ليزيد بن معاوية. ويعتقد آخرون بأنها ظهرت في العصر العباسي من مجموعة أحاديث كبار متصوفي بغداد. ولهم كتابان مقدسان أحدهما يسمى «الجلوة» وفيه خطاب الإله إلى اليزيديين خاصة ويشتمل على عقيدة تناسخ الأرواح، ويؤكد أن الكتب السماوية بدلت وحرفت. أما الكتاب الثاني فيسمى «مصحف رش» أي الكتاب الأسود، وفيه الشرائع التي أنزلت إليهم. ومنها الإباحية، وشرب الخمر، وارتكاب الفواحش.
لكن يدافع د. ميرزا حسن دنايي عنها ويرى أنها بريئة من عبادة الشيطان، وتؤمن بالله الواحد الأحد ولا تقبل له شريكًا، وطاووس ملك هو اسم من أسماء الله. وظهر هذا الاتهام ضدها في العهد العثماني عام 1791 حينما اصدر أحد الأئمة وبتحريك من سليمان باشا فتوى تحرض على قتل اليزيدية، لغايات سياسية بحتة من أجل الاستيلاء على أملاكهم وعقاراتهم وسبي نسائهم. والله حسب اليزيدية هو الذي خلق نفسه، ومن ثم خلق كل شيء بما فيه الخير والشر. واليزيديون يحرمون الأعمال الشريرة والتعدي على الغير، ويقدمون جل احترامهم- حسب قول ميرزا- لأتباع كافة الديانات الأخرى ولكل الأنبياء والرسل والكتب والتعاليم المقدسة. بل يزعم ميرزا أنهم لا يؤمنون بوجود الشيطان أو ملاك الشر، حيث إن الملائكة السبعة في اللاهوت اليزيدي خيرة كلها وتدير أمور الدنيا بأمر من الله تعالى(3).
ومن وجهة نظري يبدو أن الطائفة اليزيدية تقلبت في أطوار مختلفة على مر القرون، فدخلتها عناصر غنوصية ويهودية ونصرانية وفارسية، كما تأثرت بالإسلام، وتوالى عليها التحريف والنقص والتبديل حتى اليوم. ويبدو أن رأي د.ميرزا يدور حولها في مرحلتها الأخيرة تحت التأثير الإسلامي. لكنه لا يذكر ذلك.
عودة إله الشر في العصور الوسطى الأوروبية
رغم عدم وجود كيان شيطاني قوي عند اليونان فقد نشأ الإيمان بإله الشر في الغرب عند بعض الفرق المسيحية تحت تأثير الديانة الزروانية الفارسية وبعض نصوص العهد الجديد المتأثرة بالثنوية. وأبرز فرقه «البوجمولية» المنشقة عن المسيحية في آسيا الوسطى والبلقان. وتؤمن بإله شرير وإله خير، وأنزلت إله الشر«ساتانيل» منزلة رفيعة، واعتبرته الابن الأول المتمرد على الإله الآب، وآمنت بأن إله الشر خلق العالم وآدم من أجل احتباس الروح في المادة. وأرسل الله الآب ابنه الثاني المسيح من أجل إنقاذ العالم. وتم إعدام مؤسسها سنة 1118م.
وفي القرن 11 نشأت فرقة أخرى هي «الألبجنسية» بجنوب فرنسا، تعتبر أن الأرواح خلقت من مبدأ خير، بينما المادة خلقت بواسطة مبدأ الشر الأزلي. وتعتقد أن الله لم يخلق هذا العالم المادي، بل هو من خلق الشيطان. وهي منشقة عن المسيحية، وتعتبر أن المسيح ملاك وجسده وهم أو شبح. وهي ليست إباحية، وتحرم الفواحش، وتدعو إلى العمل، وتنكر البابوية الكاثوليكية وتعتبرها دجلًا.
وثمة فرقة أخرى منشقة عن المسيحية ظهرت في ألمانيا في القرن 12 ، هي «الكاثارية»، وتقوم عقيدتها على احتقار الحياة والمادة لأنهما من صنع إله الشر الذي سجن الروح في المادة، ولهذا الإله النفوذ والسيطرة على الأرض. ولذا أرسل الإله الأكبر المسيح إله الخير ليعلم البشرية طريقة النجاة! وفي عام 1208م شن عليهم البابا أنوسينت الثالث حربًا دامت عشرين عامًا، تلا ذلك ظهور محاكم التـفتيش فتم الـقـضاء عليهم في القرن الرابع عـشر.
ولم تعبد هذه الفرق إله الشر على عكس ما هو شائع، لكن من جهة أخرى ظهرت عبادة الشيطان في الغرب في القرون الوسطى، وتدور حول الاعتقاد بأن الشيطان إله الأرض، والله إله السماء، وهما متكافئان في القوة، ويتصارعان صراعًا قويًا، ويتساجلان النصر والهزيمة، ولذا فالعالم محل نزاع بين القوى السفلى الممثلة للشر والقوى العليا الممثلة للخير. وتكشف الحالة الحاضرة للصراع عن انتصار الشيطان؛ حيث تبدو واضحة سيادة الشيطان على العالم الأرضي، لذا يرون من الضروري التقرب من الشيطان واتباع أوامره خوفًا من شروره! وقد مارس عبدة الشيطان طقوسهم بعيدًا عن الأعين في الجبال والغابات والأودية، في حفلات جنسية إباحية وتضحيتهم بالبشر وخاصة الأطفال وأكل لحومهم. وسبوا المسيح وحوارييه والقديسين، ودعوا إلى الانتقام من البابا والملوك المسيحيين وتدنيس كل ما هو مقدس. ويزعم بعضهم أن الشيطان يزورهم في صورة امرأة.
وقد وصلتنا وثيقة من عام 1022م في أورلنس بفرنسا، أشارت إلى أنه حوكم عدد من الأفراد لاشتراكهم في عبادة الشيطان. كما ظهرت فرق مشابهة في إنجلترا والنمسا تبتهل للشيطان. وقد اكتشفت الكنيسة هذه الفرق، وقامت بحرق مجموعة من أتباعها وقتلت زعيمها ما بين عام 1310م وعام 1335م . ولكن الحرق والقتل لم يقضِ على عقائدهم الشيطانية، إذ ظهرت بمدينة «تولوز» جماعة تدعو لنفس العقائد، لاسيما التضحية بالأطفال، وقد خطفت مئات الأطفال لهذا الغرض بين عامي 1432-1440م.
وثمة إشارات في المراجع المختلفة تصنف فرسان الهيكل وجمعية الصليب الوردي في القرون الوسطى مع عبدة الشيطان وتنسب لهم كثيرًا من المعتقدات المذكورة أعلاه. وظهر في القرن السابع عشر فرق مشابهة مثل «ياكين»، والشعلة البافارية، والشعلة الفرنسية، وأخوة آسيا، وكلها ذات طقوس ومفاهيم تؤله الشيطان.
الأديان الكتابية: نمط آخر لرؤية الشر في العالم
هناك نمط آخر في اليهودية والمسيحية لرؤية الشر في العالم، وهو النمط الذي يعد الشيطان هو الأساس في وجود الشر في العالم، لكن هذا الشيطان ليس كائنًا قديمًا أزليًا، ولكنه مخلوق، كان في البدء خيرًا، ثم تمرد على الأمر الإلهي وتحول كائنًا شريرًا يسعى لغواية البشرية.
إن الكتاب المقدس في رؤيته للعالم لا يستطيع أن يحقق اتساقًا داخليًا في نسق عقائده دون افتراض شيطان ماكر يلعب دورًا رئيسًا منذ بداية التاريخ البشرى في محاولة إضلال بنى الإنسان. ولذا فإن اليهودية والمسيحية من النمط الذي يرد الشر إلى الشيطان المتمرد. يقول الأب كزافييه ليون دوفور اليسوعى:«إن الكتاب المقدس، تارة تحت اسم «الشيطان» (بالعبرية Satan = المقاوم)، وتارة تحت اسم «إبليس» (باليونانية diabolos= المشتكى زورًا) يشير إلى كائن شخصى غير مرئي في حد ذاته، ولكنه يظهر بعمله أو بتأثيره إما من خلال نشاط كائنات أخرى (شياطين أو أرواح نجسة) وإما من خلال التجربة. وعلى كل، فإن الكتاب يبدو في هذا الشأن، خلافًا للحال في فترة اليهودية المتأخرة، وفي غالبية آداب الشرق القديم، على جانب من الإيجاز الشديد، قاصرًا على إرشادنا عن وجود هذا الكائن وعن حيله، وعلى إرشادنا عن وسائل الحماية منها»(4).
ففي اليهودية الوضعية(5) نجد معنى الشيطان هو الخصم، وهو لفظ مأخوذ من فعل عبري معناه «يكمن»، «يقاوم»، فهو أكبر عدو لله وللناس، وتتضح المطابقة بين «إبليس» و«الشيطان» من (رؤ 12 : 9 ، 20 : 2). وتستخدم الإشارات إلى الشيطان في العهد القديم الكلمة بدون «الـ»التعريف بمعنى «عدو»، وهكذا ترجمت في (1 صم 29 : 4) عن داود كعدو محتمل في المعركة، وفي (1 مل 11:14 و23 و24 و25 ) ترجمت خصمًا. وفي سفر العدد (22 : 22) ترجمت «يقاوم». واستخدمت بلفظها للدلالة على خصم بشري . أما بأداة التعريف «أل» فيصبح اسم علم للدلالة على «الشيطان» بالذات ، وهو ما نجده مثلًا في أيوب (1، 2)، زكريا (3 : 1، 2)، إذ واضح أن الإشارة هنا إلى كائن غير بشري . وفي ( 1 أخ 21: 1) ترد الكلمة بدون «أل» التعريف ولكن واضح أيضًا أن المقصود بها هو الشيطان نفسه (انظر 2 صم 24 : 1).
ويقول البعض إن صورة الشيطان في العهد القديم لا يبدو منها أنه كائن شرير أساسًا بل يبدو كائنًا ملائكيًا، عمله أن يمتحن الناس. ولا شك أن الصورة الكاملة للشيطان لا تتضح تمامًا في الإشارات القليلة إليه في العهد القديم، ولكن من الواضح أيضًا أن اللمحات المسجلة عن نشاطه تكشف عن أنه يعمل لمقاومة كل خير للإنسان، فنرى في أيوب (1، 2) بكل جلاء طبيعته الخبيثة، كما أنه هو الذي أغوى داود ليعد إسرائيل فيجلب السخط عليه، كما انتهره الرب من أجل شكواه ضد الكاهن يهوشع. ولا تذكر كلمة شيطان في أسفار «الأبوكريفا» إلا في يشــــــوع بن سيراخ (21 : ). أما حكمة سليمان ( 2 : 24 ) فتذكر كلمة «ديابولس».
وفي سفر أشعياء النبى يتم تصوير الشيطان على متكبر أراد أن يصير مثل العلي، جاء في سفر أشعياء النبى «كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح. كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم. وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السموات، أرفع كرسيًا فوق كواكب الله، أصير مثل العلي.. لكنك انحدرت إلى الهاوية إلى أسافل الجب» (أش 12:14-15).
ورغم أن ماهية الشيطان في المسيحية التاريخية أكثر وضوحًا من الديانة اليهودية التاريخية؛ فإنها تأثرت بالأديان الوضعية في تصورها للشيطان؛ حيث اعتبرته أمير الظلام، مثل إله الظلام في الزرادشتية المحرفة والزروانية وغيرهما من الديانات الثنوية، وهو رئيس هذا العالم، جاء في إنجيل يوحنا، الإصحاح12: 31:«الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجًا». والعالم الذي يحكمه هو النظام العالمي الحالي القائم على مبادئ إبليس وأساليبه وأهدافه (2 كو 4 : 3 و 4 ، أف 2 : 2 ، كو 1 : 13 ، 1 يو 2 : 15 - 17). فالحقد والجشع والطمع والأنانية والمكر والكراهية إلخ، من عمل الشيطان ، «الروح الذي يعمل في أبناء المعصية» (أف 2:2). وعبارة «العالم كله وضع في الشرير» (1 يو 5 : 19). ومن أسمائه التي تكشف عن ماهيته في العقيدة المسيحية «المضل لكل العالم»(رؤ 12: ) و«التنين العظيم» (رؤ 12: 9)، و«العدو» (مت 13:28 و39)، و«الشرير» (مت 13: 19 38)، و«أبو الكذاب» (يو 8 : 44)، و«الكذاب» (يو 8 :44)، و«القتَّال» (يو 8:44)، و«الحية القديمة» (رؤ 12: 9)، و «المجرب» (مت 4 : 3 ، 1 تس 3 : 5)(6).
وهو إله الدهر ففي رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، الإصحاح4:« ولكن إن كان إنجيلنا مكتومًا فإنما هو مكتوم في الهالكين، الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين». وبيده مقاليد الريح والهواء، جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، الإصحاح2 :«حسب رئيس سلطان الهواء والروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية».
التصور الفلسفي للشيطان في العصر الحديث
هناك من الفلاسفة من نظر للشر نظرة مختلفة عن النظرة المسيحية،مثل كنت. لكن كان للتصور المسيحي للشيطان باعتباره منبع الشر تأثير على بعض الفلاسفة المحدثين الآخرين، مثل ديكارت. في حين أن هيجل يؤكد أن الوقوع في الشر والانشقاق، ثم يقظة الوعي تنبع من طبيعة الإنسان ذاتها، وهو في ذلك يختلف عما ترويه قصة السقوط في الكتاب المقدس عندما نسبت تخلي الإنسان عن وحدته الطبيعية إلى غواية خارجية هي الشيطان المختفي في شكل الحية. لكن هيجل يقبل العقيدة المسيحية عن الخطيئة الأصلية!
وإذا ما بدأنا حسب الترتيب التاريخي نجد ديكارت شك في كل شيء، بما في ذلك وجود نفسه ووجود العالم الخارجي، افترض وجود الشيطان باعتباره كائنًا شخصيًا غير مرئي في حد ذاته، ولكنه يظهر بعمله أو بتأثيره وله القدرة على تضليل حواسنا وخداع إدراكاتنا.
يقول J.H.Hick على لسان ديكارت:«ربما للوصول إلى منتهى الشك، يوجد شيطان ماكر ذو قدرة كاملة، وهو لا يضلل حواسنا فقط، بل يتلاعب كذلك بعقولنا»(7)..«وبالنسبة لإمكانية وجود شيطان ماكر يمتلك قوة فوق عقولنا تقوض كل الأدلة، فإن ذلك الشيطان يستطيع (بواسطة التلاعب بذاكرتنا) أن يجعلنا نعتقد أن حجة ما صحيحة مع أنها ليست صحيحة»(

.
إن ديكارت رافع لواء العقلانية في مطلع العصور الحديثة - هكذا يعتبر نفسه وهكذا يعتبره الكثيرون - لم يستطع أن يعتق نفسه ويفلت بأفكاره من أسر الرؤية المسيحية للشيطان، حيث قدم رؤية فلسفية لا يمكنها أن تتواصل وتتسق في بنيتها المنهجية الداخلية دون افتراض وجود هذا الشيطان الماكر، يقول ديكارت:«سأفترض، لا أن اللّه - وهو أرحم الراحمين وهو المصدر الأعلى للحقيقة - بل إن شيطانًا خبيثًا ذا مكر وبأس شديدين قد استعمل كل ما أوتي من مهارة لإضلالي؛ وسأفترض أن السماء والهواء والأرض والألوان والأشكال والأصوات وسائر الأشياء الخارجية لاتعدو أن تكون أوهامًا وخيالات قد نصبها ذلك الشيطان فخاخًا لاقتناص سذاجتي في التصديق، وسأعد نفسي خلوًا من اليدين والعينين واللحم والدم، وخلوًا من الحـواس، وأن الوهم هو الذي يخيل لي أني مالك لهذه الأشياء كلها. وسأصر على التشبـث بهذا الخاطر، فإن لم أتمكن بهذه الوسيلة من الوصول إلى معرفة أي حقيقة فإن في مقدوري على الأقل أن أتوقف عن الحكم، ولذلك سأتوخى تمام الحذر من التسليم بما هو باطل، وسأوطن ذهني على مواجهة جميع الحيل التي يعمد إليها ذلك المخادع الكبير، حتى لا يستطيع مهما يكن من بأسه ومكره أن يقهرني على شيء أبدًا»(9).
والشيطان في الإيمان المسيحي روح رهيب بحيله وشراكه وخداعه ووساوسه، ومع ذلك يظل عدوًا مهزومًا عن طريق الاتحاد بالمسيح بالإيمان والصلاة التي تساندها دومًا صلاة يسوع. وهكذا فالنجاة الدينية لابد لها حتى تتحقق من الانتصار على الشيطان بالاستنجاد باللّه. وموقف ديكارت من طرق الانتصار على الشيطان موقف في ظاهره فلسفي وفي حقيقته لاهوتي مسيحي.. كيف؟
من الظاهر أن آلية النجاة الفلسفية عند ديكارت تتحدد في «الفكر»، لكن هل «الفكر» وحده هو سبيل النجاة الكافي بذاته، أم أنه بحاجة لضمان إلهي، ومن ثم تصبح النجاة الفلسفية ذاتها غير ممكنة إلا بتحقيق النجاة الدينية أولًا؟ في الواقع، أن ثمة دورًا منطقيًا في موقف ديكارت، حيث إنه يستخدم الفكر الواضح كآلية لا تخدع للاستدلال على وجود اللّه، لكنه من ناحية أخرى يلوذ باللّه الصادق من أجل ضمان مصداقية الفكر الواضح ضد ألاعيب الشيطان الماكر. فإذا كان ديكارت يصرح بأن الفكر يكتشف نفسه في اللحظة التي يقوم فيها الشيطان بممارسة أفعال الخداع والتضليل المختلفة، وكأن يقين الفكر «أنا أفكر إذن أنا موجود thinking, Therefore I exist، حقيقة أولى Apriori متسمة بالوضوح والتميز، حيث إن الشيطان يستطيع أن يشكك الإنسان في كل شيء سوى أنه موجود(10) - إذا كان الأمر على هذا النحو تارة، فإنه تارة أخرى وفي نصوص أخرى من الكثرة بمكان، يؤكد أن هناك حقيقة حدسية أسبق من حقيقة الفكر منطقيًا، لأنها هي التي تضمن صحة الفكر نفسه بوضوحه وتميزه ضد عوامل الخداع المختلفة بما فيها الشيطان، أي أن الفكر يستلزم أولاً ضامنًا له هو «اللّه الصادق» الذي لا يخدع، والذي لا يسمح للشيطان أن يتلاعب بأفكار الإنسان، فهو مصدر الحقائق وهو ضامنها؛ ومن هنا فهو «المخلّص» الحقيقي من براثن الشك؛ بما له من أسبقية منطقية وأنطولوجية في عملية العبور من الشك إلى اليقين، إنه بمنزلة الجسر الذي يعبر عليه الفكر تلك الهوة المحفورة بيــن الجانبين، ومن ثم فإن آلية النجاة الفلسفية تظل بحاجة دومًا إلى تدعيم من آلية النجاة الدينية. مما يدل على أن مفهوم الشيطان رمز الشر، والشر هنا هو الشك، حاضر في بنية التفكير الديكارتي.
لكن هناك من الفلاسفة من نظر للشر نظرة مختلفة عن النظرة المسيحية، مثل «كنت» الذي يبدأ في تناول الخطيئة عند أدنى مرتبة أخلاقية وهي الشر، ويطرح المسألة برمتها طرحًا فلسفيًا يرفض فيه الخطيئة الأصلية التي تقول بها المسيحية. والميول هي التي تسمح بالانحراف نحو الشر، فهي الأساس الذاتي لإمكان النزوع أو الشهوة، وهي قد تكون فطرية طبيعية، بيد أنها غالبًا ما تكون مكتسبة بسبب خطأ يقع فيه الإنسان، وهذا ما يجب تصوره. والميول تتنوع إلى ثلاثة أنواع، هي ضعف العزيمة أو القلب، وهو ما عبر عنه بدقة القول الآتي:«عندي الإرادة بيد أني أفتقر إلى التنفيذ»(11)، والنجاسة أو عدم النقاء، تحدث عندما لا يكتفي الفعل بالقاعدة الخلقية، ويحتاج إلى دوافع أخرى(12)، وأخيرًا الفساد الذي ينشأ عندما تميل الإرادة إلى تفضيل دوافع دنيا على الدوافع الخلقية(13).
وتأخذ هذه الميول مجراها نتيجة سوء استعمال الإرادة الحرة، عندما لا يسلك الإنسان وفقًا للواجب، وإنما بدافع من بعض المغريات، وهذا يعني أن الشر لا ينشأ عن وجود إرادة شريرة كامنة أنطولوجيا في الطبيعة الإنسانية، وإنما عن ضعف هذه الطبيعة عندما لا تفصل بين بعض الدوافع وبعضها الآخر على أساس القاعدة الخلقية(14).
إن فهم كنت على هذا النحو لا يمكن أن يؤدي بأي حال إلى الاعتقاد الذي ذهب إليه د.بدوي عندما قال:«إن النتائج المترتبة على نظرية «كنت» هذه في الشر الأصيل نتائج بالغة الخطورة ولو استخلصت كلها بعمق واستقصاء لأفضت بـ«كنت» إلى متاهات لاهوتية بعيدة كل البعد عن نقده العقلي: مثل التبرير، الغفران، القدر السابق، التحول...إلخ(15).
ويذهب «كنت» إلى أن أفسد تفسير لأصل الشر الأخلاقي القول إنه خطيئة أولى منتقلة بالوراثة من الآباء إلى الأبناء، وهو في هذا يتفق بوضوح مع الإسلام . ويستند «كنت» في رفضه للخطيئة الأولى إلى التحليل العقلي وتأويل نصوص الكتاب المقدس التي تؤكد حدوثها، وينظر إلى قصة السقوط باعتبارها صورة مجازية(ليست حقيقية) تصور ما نفعله نحن كل يوم عندما نغلب بإرادتنا دوافع حسية على ما يقضي به القانون الأخلاقي(16).
إن «كنت» يرفض مواقف القديس أوغسطين ومارتن لوثر(17)، بالإضافة إلى رفضه لكل محاولة ترمي إلى إخضاع الإنسان لتحمل خطيئة أصلية لم يتسبب هو في جلبها لنفسه. ومن هنا فإن جوته وهردر وشيلر لم يحسنوا فهم موقف «كنت» من الخطيئة، عندما اعتبروا أنه قد لطخ رداءه الفلسفي بنظرية الخطيئة الأصلية، وفتح ثغرة لاعقلانية في نسقه النقدي العقلاني المحض.
في حين أن هيجل يحلل موقف المسيحية من الشر عبر تحليله لقصة السقوط؛ سواء في «محاضرات في فلسفة الدين» أو في «موسوعة العلوم الفلسفية»، ويذهب في الأخيرة إلى أن الإنسان في مبدئه يتمتع بالبراءة الأولى، لكنه انقطع مع هذه البراءة، وانشق عن الطبيعة، واختلف مع الله، نتيجة التدخل الشيطاني.. وهذا هو معنى الوقوع في الشر، ومعاناة الألم والشقاء في العالم. وهو ما عبرت عنه قصة السقوط(18). وتحكي قصة السقوط أن آدم وحواء كانا يعيشان في جنة عدن، حيث نمت شجرتان: شجرة الحياة، وشجرة معرفة الخير والشر. وتقول القصة في سفر التكوين إن الله حرم عليهما الأكل من شجرة المعرفة. أما الشجرة الأخرى فقد لزمت القصة الصمت بصددها. ويدل تحريم الأكل من شجرة المعرفة دلالة واضحة على أن الإنسان يجب ألا يطلب المعرفة، وعليه أن يستمر في حالة البراءة الأولى.
ولا يجد هيجل شكًا في أن براءة الأطفال تحوي جانبًا مدهشًا ومثيرًا للإعجاب، فهذه البراءة تعرفنا بما ينبغي أن تفوز به الروح الناضجة لنفسها. فليس انسجام الطفولة إلا منحة من الطبيعة، بينما الانسجام الثاني يتوقف على الكدح والمكابدة والاجتهاد والتضحية، حيث يلزم أن يأتي بعد جهد جهيد من الروح وارتقائها في مضمار التهذيب والثقافة. ولذا قال المسيح:«الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السموات»(19). إنه قول يشير إلى هذا المعنى في اعتقاد هيجل، أي أنه لا يريد منا أن نظل أطفالًا بل أن نصل بجهدنا إلى مرحلة الانسجام الثانية.
فلكي يخرج الإنسان من الشقاء عليه أن يحول العالم ويتعامل معه بالعمل بالكدح، أما المرأة فلابد من أن تلد بالألم والمعاناة. وهكذا تجد أن الإنسان – وفق التحليل الهيجلي(20) – في تعامله مع الأشياء الخارجية لا يتعامل إلا مع نفسه، والعمل هو الذي يعيد إليه وحدته مع الطبيعة، بيد أنها ليست وحدة اندماجية مثلما كان الحال في البداية، وإنما وحدة يتخللها انفصال يتمثل في شعور الإنسان بأنه مختلف عن الطبيعة التي يعمل على الاتحاد بها.
وحسب العرض الهيجلي في الموسوعة لا تنتهي قصة السقوط بطرد آدم وحواء من الجنة بل هي تستمر لتخبرنا أن الله قال:«هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفًا الخير والشر»، (21) أي أن المعرفة أمر إلهي ولم تعد عملًا الآن مثل الماضي، وتدحض هذه الآية فيما يرى هيجل الزعم القائل إن الفلسفة تهتم بتناهي الروح فحسب. فالفلسفة معرفة، ومن خلال المعرفة حقق الإنسان لأول مرة شعوره الأصلي بأنه صورة الله. وهذا يعني أن الإنسان – من زاوية المعرفة – لامتناه وخالد. لكنه في الجانب الطبيعي متناه وفان، وهذا ما يقرؤه هيجل في بقية الآية السابقة التي تذكر أن الله طرد الإنسان من جنة عدن بعد أن أكل من شجرة المعرفة حتى لا يأكل من شجرة الحياة»(22):«والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضًا ويأكل ويحيا إلى الأبد، فأخرجه الرب الإله من جنة عدن..».
وعلى هذا يرى هيجل أن العقيدة المسيحية عن الخطيئة الأصلية حقيقة عميقة! رغم أن عصر التنوير الحديث يفضل الإيمان بأن الإنسان خير بطبيعته، وأنه يسلك سلوكًا صوابًا بمقدار ما يواصل الالتزام بطبيعته الحقيقة. ومن الواضح أن الإسلام ضد فكرة الخطيئة الأصلية، فكل إنسان يولد على الفطرة، ويبدأ حياته بصفحة جديدة لا تشتمل على خطيئة أصلية موروثة، فلا تزر وازرة وزر أخرى، وكل نفس بما كسبت رهينة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهكذا يتوافق صريح المعقول مع صحيح المنقول في الإسلام، في حين يتورط هيجل في عقائد «لا عقلانية» بسبب عقلانيته المنحازة!
لكن كيف يتغلب الإنسان عند هيجل على الشر والانشقاق ولحظة الاختلاف داخل الحياة الإلهية وفي العالم؟
عن طريق المصالحة وعودة الإنسان إلى الله. ومضمون هذه المصالحة يتمثل في اتحاد الحقيقة المطلقة الإلهية والذاتية الفردية الإنسانية؛ فكل إنسان هو الله، والله إنسان فردي. ويعتبر هذا من المسلمات التي يصادر عليها الوعي الديني المسيحي الذي يعتقد بأن الله ذاته صار بشرًا، جسدًا، وتجلى كإنسان فرد.إن منعطف حياة الله في المسيحية هو ذلك الذي يخسر فيه وجوده الفردي ويكف معه عن أن يكون ذلك الإنسان المتعين. ومن ثم فإن المنعطف يتمثل في سيرة آلام المسيح وعذابه على الصليب وجلجلة الروح ونكال الموت.
وفي شطحة فلسفية لا عقلانية يرى هيجل في موت الإله في العقيدة المسيحية بعثًا حقيقيًا للروح، لأن موت الإله ليس نفيًا له وإنما نفي للوجود المتعين الذى تظاهر فيه، ثم تحوله إلى روح كلي تعيش في صميم الجماعة المسيحية(23). يقول هيجل:«الله ذاته قد مات» كما قال لوثر في أحد أناشيده. على هذا النحو تم التعبير عن إدراك أن البشري، والتناهي، والغيرية، والضعف، والسلب، كلها موجودة في الله، وتمثل مرحلة في ما هو إلهي. إن التناهي، والسلب، والغيرية، لا توجد خارج الله، ولا تشكل الغيرية حاجزًا أمام الاتحاد مع الله. لقد تم الوعي بأن الغيرية، السلب، لحظة في الألوهية ذاتها. هنا تظهر أرقى فكرة روحية»(24)!!
ألا ما أسخف مغالطات بعض الفلاسفة! إن الوعي الديني التنزيهي ليس بحاجة لمثل هذا النوع من الوحدة التي تتحدث عنه الفلسفة الهيجلية، تلك الوحدة التي تقتضي موت إلهه! حتى ولو على سبيل التمثيل، لأن في ذلك ردة إلى مرحلة الأديان البدائية في مصر وسوريا والتي كانت تعتبر الموت لحظة ضرورية بالنسبة لله على نحو ما تجلى في عقيدة أوزريس المصرية وعقيدة أدونيس السورية، فالإله يتضمن هنا سلبه، أي أنه يموت!
فالمسيحية كما تشكلت بعد المسيح، في أجيالها الأولى ما هي إلا صورة جديدة من تلك العقائد القديمة ملقحة بمفهوم الإله اليهودي، وهذا ما يشير إليه أورسيل ماسون عندما يقرر أن الأجيال المسيحية الأولى قامت بالتأليف المنتظر منذ زمن طويل بين إله الساميين، ومفهوم الإله عند الإيجيين والأسيانيين، في شخصية المسيح المثالية. وإذا كان يهوه هو التعبير المباشر، القريب، عن الإله – الأب، فإن الآلهة التي تعذبت من أجل إنقاذ الإنسانية سواء كانت فريجية أم سورية أم مصرية، هيأت لإنشاء مفهوم الإله الابن، مفهوم الإله الذي يعاني الموت من أجل إنقاذ الإنسانية من الشيطان أو من الشر(25).
عبادة الشيطان في العصر الحديث
رغم دخول الغرب في عصر الحداثة والعقلانية، بعثت عبادة الشيطان من جديد. وتدور عقائد عبدة الشيطان عامة في العصر الحديث على أن الشيطان يمثل الوجود الحيوي والروحانية الحقيقية والفكر الذكي، في مقابل الأمل الكاذب الوهمي! ويدعو إلى الانتقام، بدلًا من الحب الزائف للحاقدين وجاحدي الجميل. ويمثل الحكمة غير المزيفة في مقابل ما يوجد في الأديان من خداع النفس بأفكار زائفة؛ فالشيطان يعبر عن الانغماس الذاتي في الأهواء والشهوات والتمتع ويقبل كل ما يطلق عليه خطايا أو آثام باعتبارها طاعات؛ لأنها تؤدي إلى الإشباع العضوي والعقلي والعاطفي.
وفي القرن التاسع عشر دعا إلى عبادة الشيطان الساحر الإنجليزي بريت أليسر كرولي Brite aleiser Crowly 1875-1945م. ومع دخول القرن العشرين إلى منتصفه، دخل هذا الدين الخرافي مرحلة ثانية, بصدور كتاب لا فالي «الكتاب الشيطاني المقدس» سنة 1957م, شرح فيه طرق ممارسة شعائر عبادة الشيطان, والأركان الأساسية للإيمان بالشيطان كإله تتجسد قوته في التحكم بعناصر الطبيعة، وإنكار البعث والجنة والنار. ومن ثم دعا إلى استغلال الحياة في ممارسة كل الرغبات، والشذوذ, والسحاق، والاستعانة بالسحر والشعوذة للحصول على أي شيء، ودعا إلى عدم قتل الحيوان(عدا البشر) إلا دفاعًا عن النفس أو لتقديمها قربانًا للشيطان!
وفي سنة 1966م ظهر كتاب «إنجيل الشيطان» في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسس مؤلف الكتاب أنطوان تليدر ليفي أول معبد لعبادة الشيطان، ثم أنشئت معابد أخرى في عدة بلدان أمريكية وأوروبية. وفي هذا السياق من التخبط الذهني والروحي ظهرت عدة مؤلفات له:«الطقوس الشيطانية»، و«الساحر الشيطاني»، و«مذكرة الشيطان». كما ظهرت كتابات أخرى مثل:«صمت إبليس» تأليف د.لورانس بازدر. وتكونت طائفة أخرى بزعامة «مايك وازنكي» تزعم أن الملة الشيطانية تشمل بعض التيارات المسيحية مثل روحانية العصر الحديث. كما توجد جماعات عبدة الشيطان في منطقة «برواكن بابك» المقدسة عند عبدة الشيطان بجبال هيرتس بألمانيا.
وفي عام 1980م فضحت ميشيل سميث في كتابها «ميشيل تتذكر» كل رذائلهم، بعد أن خرجت من طائفتهم، ووصفت ما تعرضت له من تعذيب جنسي، وشرحت كيف يقومون بعمليات تضحية بشرية كجزء من سحرهم الأسود الذي يقوم على الاعتقاد بأن الألم الذي يتعرض له الضحايا يزيد من فعاليته.
ومن أسف فقد وجدت هذه المعتقدات الشيطانية لها سبيلًا في بعض البلدان العربية، مثل مصر والأردن والمغرب، نتيجة حياة الترف والتحلل الاجتماعي والفراغ الروحي الموجود عند بعض فئات الطبقات الغنية. وقد تم القضاء على أتباعها بالسجن.
وتبقى الكلمة الأخيرة للدين المهيمن الذي استطاع تحرير المؤمنين به من أوهام الوجدان، وخيالات النفس، وضلالات العقل، وخرافات الديانات الوضعية. تبقى الكلمة الأخيرة للإسلام.
عالم بلا خوف: الإسلام
يختلف الإسلام بوضوح عن كل الديانات الوضعية، بل ويختلف عن اليهودية والمسيحية التاريخيتين في تفسير وجود الشر في العالم، وفي النظر إلى الشيطان من حيث طبيعته ودوره، وكيفية التغلب عليه، فضلًا عن وجود عناصر أخرى في الإسلام غير الشيطان لتفسير الشر في العالم. وقد استطاع هذا الدين أن يتخلص من أساطير القدماء ومن أوهام البشر ومن مغالطات بعض الفلاسفة المتأثرين بالديانات الوضعية أو المحرفة.
فالشر موجود من أجل إمكان الحرية الإنسانية؛ لأنه يمتنع القول إن الإنسان حر إذا كان مجبولًا على الخير فقط. ولا يكتسب فعل الخير ميزته إلا إذا كان فعل الشر ممكن الحدوث. ومن هنا يمكن القول بأن الإسلام لا يقول بطبيعة شريرة في الإنسان، وإنما إمكانية للشر وللخير، موجودة في الإنسان كأساس ضروري للحرية، فإمكانية الشر والخير هي التي تجعل الحرية ممكنة، والشر ليس محركه الشيطان فقط، بل النفس أيضًا عندها القابلية؛ يقول تعالى :}وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا|(الشمس: 7-10). فلا يتصور المرء إرادة حرة دون أن يكون لديها إمكانية فعل الخير وإمكانية فعل الشر.
والأمر كله يتوقف على الإرادة الإنسانية في امتحان الشر والخير،}وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ|(لأنبياء:35)، فالشر امتحان، والخير امتحان، أمام الإرادة الإنسانية. والإنسان بإمكانه دومًا أن يتجنب هذا الشر إذا ما أحسن الاختيار ولم يسئ استخدام حريته.
وليس على المرء أن يخشى الشر وممثليه من الجن والإنس، بل عليه أن يواجهه بكل قوة دون خوف!}إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ|( آل عمران:175)..}فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً|(النساء:76).
إن الشيطان في الإسلام –ولأول مرة في تاريخ الأديان-عدو لا يملك إلا الوسوسة، ولا يستطيع إلا الدعوة والتحريض والإغواء، باعترافه الأخير:}وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي|(إبراهيم:22).
إنه ليس إلهًا كما هو في الهندوسية والزرادشتية المحرفة والزروانية والجماعات المسيحية المنشقة في العصور الوسطى، وليس إلهًا للدهر كما هو عند المسيحية في العهد الجديد، إنه مجرد مخلوق من مخلوقات الله تعالى، وليس أزليًا أو كائنًا من ذاته بدون خالق، إنه من طائفة الجن المخلوقة من النار }وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ|(الحجر:27).
ولذا له طبيعة مختلفة عن الإنسان، ومن ثم فإن القوانين التي تحكم عالمه مختلفة، وله قدرات خاصة، لكنه كائن محدود ليس كامل القدرة ولا العلم. ويرى الإنسان في حين أن الإنسان لا يراه، ومع ذلك لا يملك إلا الفتنة. وله تأثير، لكنه تأثير محدود بالوسوسة. وله سلطان على الغاوين لا المؤمنين }إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ|(الحجر:42) . وكيده ضعيف}إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً|(النساء:76).
وهذا واضح على مدى التاريخ من تخبطه في معاركه التي ينهزم فيها عند مواجهة أية طائفة قوية من المؤمنين، }أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ|(المجادلة: من الآية19).
أما انتصاراته فهي انتصارات مزيفة؛ لأنها على ضعفاء الإيمان أو غير المؤمنين}يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ|(الأعراف:27).
وما يمتع به من سلطان، فإنما هو معط له من الله ،}قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ| (الأعراف:14-15). }قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً|(الإسراء:63). وهو حر أن يعمل داخل الحدود التي سمح له بها، لكنه لا يستطيع تجاوزها}وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ|( الملك:5).
ولقد أوضح الله للإنسان طريق التغلب على الشيطان؛ فمواجهة نزغاته لا تستلزم سحرًا ولا كهانة ولا طقوسًا معقدة، بل إرادة قوية واستعاذة بالله، }وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ| (الأعراف:200)؛ فالانتصار على كل هجمات الشيطان ممكنة.
ومع أن الحكم الإلهي صدر عليه، إلا أنه مازال مسموحًا له بممارسة سلطانه المحدود كفتنة واختبار للناس لامتحان إرادتهم، وبانتهاء هذا الامتحان يتحدد المصير النهائي بالعذاب الأبدي؛ هكذا أعلن القرآن المصير المحتوم للشيطان والنهاية الأخيرة للصراع بين الخير والشر،}وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ|( إبراهيم:22).
وهكذا فإن الشيطان كائن مهزأ، ومنبوذ، يهاجمه المسلم ولا يخشاه، ويرجمه دون خوف في شعيرة من شعائر الحج؛ لأنه أصبح عدوًا مهزومًا بفضل الإيمان بالله، فليس له من سلطان عليه، إنما سلطانه على الذين لا يؤمنون. ومن ثم تحرر الإنسان مع الإسلام من عبودية كائن طالما استحوذ على النفوس الضعيفة، مثلما تحرر من كل مخاوفه الأخرى التي طالما عاش بسببها في جحيم من الخرافة والوهم والوعي الشقي. وأصبح العالم مع الإسلام عالمًا بلا خوف.
محمد عثمان الخشت ـ القاهرة :